دروس الشيخ النابلسي - محاضرات وفتاوى إسلامية
استكشف مجموعة متنوعة من دروس الشيخ النابلسي والمحاضرات والفتاوى التي تغطي مواضيع الفقه والعقيدة وتربية الأبناء في الإسلام. احصل على المعرفة الدينية من علماء الشام.
5/8/20241 min read
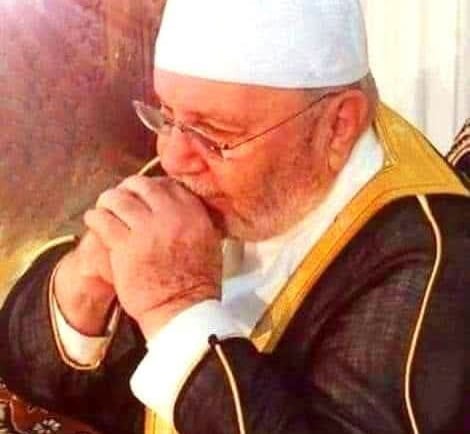
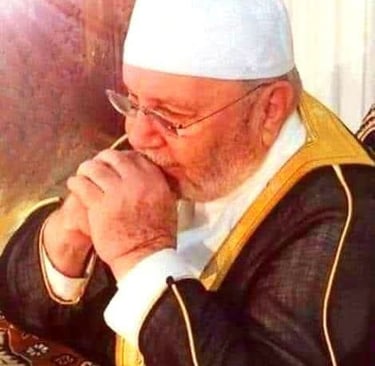
دروس فقهية
إطلاق البصر في الحرام
إطلاق البصر في الحرام هو من الأخلاق المذمومة في الإسلام، ويقصد به توجيه النظر إلى ما نهى الله تعالى عنه من المحرمات، مثل النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة، أو التطلع إلى العورات، أو مشاهدة الصور والمشاهد المثيرة. وقد اعتبر علماء الإسلام هذا الفعل بابًا من أبواب المعصية التي تضعف الإيمان وتُبعد القلب عن الله تعالى.
التعريف
يُعرّف إطلاق البصر بأنه ترك المراقبة والخشية عند توجيه النظر، بحيث ينظر الإنسان إلى ما يشاء دون ضابط شرعي أو وازع ديني. فهو نوع من الانفلات البصري الذي يعبر عن غياب الخوف من الله وعن ضعف المراقبة الداخلية. وفي المقابل، فإن غضّ البصر يعني كفّ النظر عمّا لا يحلّ للإنسان النظر إليه، التزامًا بأوامر الله تعالى.
الأدلة الشرعية
ورد النهي عن إطلاق البصر في نصوص قرآنية وأحاديث نبوية عديدة، أبرزها قوله تعالى:
﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ – [النور: 30]
وفي الحديث الشريف، قال النبي ﷺ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه:
«يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» – رواه الترمذي وأبو داود.
كما ورد في قوله تعالى:
﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ – [غافر: 19]
فسّر العلماء هذه الآية بأنها تشمل كل نظرة محرّمة أو مختلسة يقوم بها الإنسان في غياب الناس، لأن الله تعالى مطّلع على ما تُخفي العيون والقلوب.
الحكم الشرعي
اتفق العلماء على تحريم النظر إلى ما حرّم الله، سواء أكان النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة، أم إلى الصور والمشاهد المثيرة، أو غيرها من المحرمات البصرية. ويُعدّ إطلاق البصر من الصغائر التي تتحول إلى كبائر بالإصرار، استنادًا إلى الحديث النبوي:
«لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار» – رواه ابن عباس في مسند الشهاب.
ويرى الفقهاء أن النظر المحرم قد يكون سببًا في فساد القلب وحرمان العبد من لذة العبادة وقرب الله، إذ يجعل بينه وبين ربه حجابًا من الشهوات والمعاصي.
الأثر الديني والنفسي
يؤكد العلماء أن كثرة النظر المحرم تُضعف الإيمان، وتزيد من التعلق بالدنيا والشهوات. وقد ذكر بعض المفسرين أن القلب السليم المذكور في قوله تعالى:
﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ – [الشعراء: 89]
هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله تعالى.
من الناحية النفسية، أظهرت دراسات علمية حديثة أن النظر المتكرر إلى المشاهد المثيرة ينشّط مناطق محددة في الدماغ مرتبطة بالإثارة الجنسية، مما يؤدي إلى تعزيز العادات السيئة وصعوبة ضبط السلوك. في المقابل، فإن كفّ البصر عن الحرام يحقق استقرارًا نفسيًا، ويغرس الطمأنينة والرضا في النفس.
فوائد غضّ البصر
غضّ البصر من الأخلاق التي تعود على المسلم بمنافع دنيوية وأخروية. ومن أبرز فوائده:
طهارة القلب من الشهوات المحرمة، وصفاؤه من التعلّق بما لا يرضي الله.
تقوية العلاقة بالله تعالى؛ إذ يورث الله من غض بصره حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه.
حماية الأسرة والمجتمع من الفواحش والانحرافات الأخلاقية.
تعزيز المودة الزوجية؛ لأن المؤمن الذي يغض بصره يكتفي بزوجته، ويزهد فيما حرّم الله، فينمو الحب بين الزوجين على أساس من العفة والوفاء.
ويروى في الأثر: «من ترك شهوة لله، عوّضه الله إيمانًا يجد حلاوته في قلبه».
أنواع النظر
يقسم العلماء النظر إلى نوعين رئيسيين:
النظر المحرم: وهو النظر إلى ما حرّم الله من العورات أو النساء الأجنبيات بشهوة، أو النظر الخائن والمختلس، أو الإيماء بالعين على وجه الخيانة، وقد يدخل في ذلك شهادة الزور أو ادعاء رؤية ما لم يُرَ.
النظر المأذون به: وهو النظر المشروع الذي أمر به الشرع أو أباحه، كالنظر في آيات الله الكونية، والنظر أثناء الحراسة والجهاد، والنظر في الصناعات والعلوم النافعة، والنظر إلى الزوجة أو إلى ما تدعو إليه الحاجة.
قال الله تعالى في الحث على النظر النافع:
﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ – [يونس: 101]
وهو نظر تأملٍ وتفكرٍ في خلق الله ودلائل قدرته وحكمته.
البعد التربوي والأخلاقي
ينظر الفكر الإسلامي إلى ضبط البصر باعتباره جزءًا من تهذيب النفس وتزكيتها، إذ يُعدّ النظر أول طريق الشهوة والمعصية. وقد بيّن الإمام ابن القيم أن «النظر يولّد المحبة، ثم الصبابة، ثم الغرام، ثم العشق، حتى يستعبد القلب»، لذلك يُعدّ كفّ البصر من وسائل التحرر القلبي وحفظ الكرامة الإنسانية.
في الحياة الاجتماعية
يرتبط غضّ البصر بالسلوك الاجتماعي القويم، فهو يحدّ من التوترات داخل الأسرة، ويمنع التفكك الأخلاقي، ويحفظ كرامة المرأة والرجل معًا. كما أن إطلاق البصر يؤدي إلى المقارنة الدائمة وعدم القناعة، ويغرس الأنانية والاضطراب النفسي، بينما يغرس غضّ البصر الرضا والقناعة والوفاء.
الخلاصة
يُعدّ إطلاق البصر في الحرام من المعاصي التي تؤثر في القلب والسلوك معًا، وهو من الأخلاق المذمومة التي حذّر منها الإسلام لما يترتب عليها من مفاسد دينية واجتماعية ونفسية. وفي المقابل، يُعدّ غضّ البصر عبادة قلبية وسلوكًا راقيًا يحفظ الإيمان، ويزكي النفس، ويحقق الطهارة والعفة، ويجعل المسلم أكثر قربًا من الله تعالى.
أعلى مرتبة في الإيمان
تعريف المراتب الثلاث
يُقسَّم الدين الإسلامي إلى ثلاث مراتب مترابطة بحسب ما ورد في حديث جبريل المشهور: الإسلام، والإيمان، والإحسان. وقد ورد في الحديث أن جبريل سأل النبي ﷺ عن الإحسان، فقال:
«أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»
(رواه مسلم).
تُعَدُّ مرتبة الإحسان أعلى مراتب الدين والإيمان، وهي ذروة السلوك الروحي والعملي للمؤمن، إذ يعيش العبد فيها على يقينٍ دائمٍ بمراقبة الله تعالى له في كل أحواله وسكناته.
مفهوم الإحسان
الإحسان لغةً مأخوذ من "الحُسْن"، ويعني الإتقان والإجادة. أما في الاصطلاح الشرعي فهو مراقبة الله تعالى في السر والعلن، والقيام بالعبادة على وجه الكمال، بحيث يكون شعور المؤمن دائمًا أن الله مطلع عليه، فإن لم يصل إلى مقام المشاهدة القلبية، فليكن في مقام المراقبة واليقين بعلم الله به.
قال تعالى:
﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾
[غافر: 19].
فمن أيقن أن الله يعلم السر وأخفى، ضبط جوارحه، وحركاته، ونظراته، وكلماته، فلا يفعل ما يستحيي أن يفعله أمام الخلق، فكيف بخالقه سبحانه.
المراقبة والإحسان
يُعدّ مقام المراقبة أساس مقام الإحسان؛ فالمراقبة هي دوام استحضار علم الله، وأنه سبحانه رقيب على عبده في كل أحواله. قال بعض العلماء: "من راقب الله في خواطره، عصمه الله في حركات جوارحه."
فإذا صان المؤمن خواطره من الانحراف، سلمت جوارحه من المعصية، لأن المعصية تبدأ بخاطرة ثم فكرة، فعزيمة، ففعل، ثم عادة يصعب تركها.
وقال الجنيد البغدادي: "من تحقق في المراقبة، خاف على فوات لحظة من ربه لا غير."
أي أن المراقبة الدائمة لله تُثمر دوام الاتصال القلبي به، والخوف من الغفلة عن حضرته ولو لحظة واحدة.
علامات المراقبة
ذكر العلماء أن من علامات المراقبة:
إيثار ما أنزل الله على هوى النفس.
تعظيم ما عظّمه الله، وتصغير ما صغّره الله.
وقد دلّ على ذلك قوله تعالى:
﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾
[الحج: 32].
فمن عظّم أوامر الله واجتنب نواهيه، وراقب الله في السر والعلن، فقد بلغ مرتبة الإحسان.
المراقبة بين العبد وربه
المراقبة تعني خلوص السر والعلانية لله وحده. قال بعضهم: "المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل."
فالعبد الصادق يجعل سِرَّه وعلانيته سواء، فلا يظهر للناس خلاف ما يبطن، لأنه يعلم أن الله مطّلع على باطنه كما يراه الناس في ظاهره.
وقد رُوي أن عبد الله بن المبارك لما رأى الناس يكرمونه بكى، وقال: "اللهم لا تحجبني عنك بهم، ولا تحجبهم عنك بي." وهو دليل على خشية المخلصين من أن تكون شهرتهم سببًا في الغفلة عن مراقبة الله تعالى.
التعبد بأسماء الله الحسنى
يُعبِّر أهل العلم عن مقام الإحسان بأنه التعبد لله بأسمائه وصفاته، فيعبد العبد ربه باسمه "الرقيب" فيراقبه، وباسمه "السميع" فيحفظ لسانه، وباسمه "البصير" فيصون نظره، وباسمه "العليم" فينقي نياته، وباسمه "الحفيظ" فيطمئن إلى رعايته.
قال تعالى:
﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾
[الأعراف: 180].
مراتب الإحسان وأحواله
من ألطف ما وُصف به حال الإحسان قول بعضهم:
"هو تعظيمٌ مذهل، ومداناةٌ حاملة، وسرورٌ باعث."
التعظيم المذهل: امتلاء القلب بعظمة الله، حتى يذهل عن تعظيم غيره، فلا يُرى في قلبه مكان لعظمة مخلوق مهما كبر شأنه. فكلما ازداد تعظيم العبد لربه، صغرت الدنيا في عينه.
المداناة الحاملة: القرب من الله تعالى الذي يملأ القلب أمنًا وسكينة ويبعثه على الطاعة.
السرور الباعث: الفرح بالله ومعرفته، وهو سرور لا يشبه لذائذ الدنيا، بل يثمر الطمأنينة والرضا.
أثر الإحسان في حياة المؤمن
من أدرك مقام الإحسان عاش في حضورٍ دائمٍ مع الله، فيكون حياؤه من الله كحيائه من وجيهٍ كريمٍ يراقبه في كل لحظة، فيحسن سلوكه، وينتظم في قوله وفعله.
ويثمر الإحسان الطمأنينة، والثبات أمام الشهوات، والسمو عن الأهواء، إذ يرى المؤمن أن مراقبة الله تغنيه عن مراقبة الناس.
قال بعض السلف: "إذا علمت أن الله يراك، استحييت أن يراك على معصية، أو يفقدك عند طاعة."
الخلاصة
إن أعلى مرتبة في الإيمان هي الإحسان، وهي أن يعبد العبد ربَّه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يوقن أن الله يراه. وهذه المرتبة تجمع كمال العلم بالله، وكمال العمل له، وكمال الإخلاص في عبادته، وهي التي تُورث القلب السكينة، والنفس الطمأنينة، وتُبعد العبد عن الغفلة والرياء، وتجعله دائم الصلة بالله عز وجل في السر والعلن.
أحوال أهل الجنة وحقيقة السعادة الإيمانية
السعادة القلبية في الدنيا
يرى العلماء أن السعادة الروحية الناتجة عن القرب من الله تعالى تمثل أسمى درجات النعيم، وهي سعادة لا تُقارن بشيء من متاع الدنيا. فمهما بلغ الإنسان من لذائذ الدنيا، من مالٍ أو جاهٍ أو جمالٍ أو مسكنٍ فخم، فإن تلك المتع تبقى محدودة بزمنها ومادتها، بينما القرب من الله يورث في القلب سرورًا وطمأنينة لا يعدلهما شيء.
وقد استدل العلماء على ذلك بقوله تعالى:
﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾ [محمد: 6]،
أي: عرّفهم بها وعرّفهم طريقها وأذاقهم شيئًا من نعيمها في الدنيا، وهو نعيم القرب من الله تعالى.
قال بعض السلف: «في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة»، والمقصود بها جنة الطاعة والأنس بالله، التي يذوقها المؤمن في قلبه قبل أن يدخل الجنة في الآخرة.
أثر الإيمان في طمأنينة النفس
ذكر أحد العارفين قوله: «تمرّ بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيشٍ طيب»، إشارةً إلى ما يجده المؤمن من راحة قلبية وسكينة روحية عند إحكام صلته بالله تعالى.
فالإيمان الصادق يولّد سعادة داخلية لا تتأثر بظروف الحياة المادية، إذ قد يسعد المؤمن ولو كان في ضيقٍ أو سجنٍ، ويشقى الكافر ولو كان في قصرٍ فخم. فالسكينة التي يضعها الله في قلب عبده المؤمن هي النعيم الحقيقي في الدنيا، وفقدها هو الشقاء الأكبر مهما توفّر من أسباب الرفاه.
روح العبادات في الإسلام
يُفرّق العلماء بين مظاهر العبادة وحقائقها. فالأعمال الظاهرة، كالصلاة والصوم، قد تصبح شاقةً على النفس ما لم يكن القلب حاضرًا فيها، كما قال تعالى:
﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: 45].
فالخشوع هو روح العبادة وجوهرها، وبدونه تصبح الأفعال مجرد طقوسٍ خالية من الأثر.
ومن فقد لذة العبادة فعليه أن يراجع إيمانه، لأن للإيمان حلاوة من لم يذقها لم يتصل بالله اتصالًا حقيقيًا. وقد قال النبي ﷺ:
«ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا»
(رواه مسلم).
متى يذوق العبد حلاوة الإيمان
بيّن النبي ﷺ في حديثٍ آخر خصالًا ثلاثًا توصل العبد إلى حلاوة الإيمان، فقال:
«ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ:
أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا،
وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلا لِلَّهِ،
وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ»
(متفق عليه).
وهذه الصفات تمثل جوهر الإيمان الحق:
محبة الله ورسوله فوق كل حبٍّ دنيوي.
الإخلاص في المحبة، بأن تكون لله وحده لا لمصلحة دنيوية.
التمسك بالدين حتى يصبح الرجوع إلى الكفر أبغض إلى النفس من النار نفسها.
من تحققت فيه هذه الصفات وجد لذة الإيمان في قلبه، وهي لذة لا تُشترى بمال ولا تُنال إلا بطاعةٍ صادقةٍ وتجردٍ من الهوى.
حال المسلمين اليوم
يشير بعض العلماء إلى أن حال الأمة الإسلامية اليوم يشهد ضعفًا في الإيمان العملي رغم كثرة المنتمين إليها. فعدد المسلمين كبير، لكن الأثر في الواقع ضعيف بسبب غياب جوهر الإيمان وحقيقة الالتزام.
كثير من الناس يتمسكون بمظاهر الدين دون أن يتذوقوا ثمراته الروحية؛ فالإيمان لا يُقاس بالعدد، بل بالعمل والإخلاص والخلق. وقد شبّه بعض العلماء هذا الحال بمرحلةٍ يكون فيها المسلمون كالغثاء في الكثرة، بلا تأثيرٍ ولا وزنٍ في ميزان القيم.
الإيمان الحق والسكينة الدائمة
الإيمان الحق هو الذي يجعل صاحبه يرى أن السعادة في الرضا بالله، لا في زخارف الدنيا. فالمؤمن الصادق تتساوى عنده اللذائذ الدنيوية، إذ يجد راحته في ذكر الله وطاعته، كما قال تعالى:
﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28].
ولا تُنزع هذه الطمأنينة من قلبه مهما اشتدت المحن، لأنها متصلة بمصدرٍ لا ينقطع: الإيمان بالله والرضا بقضائه.
خلاصة القول
تُعد السعادة الإيمانية في الدنيا جزءًا من نعيم أهل الجنة، إذ يعيش المؤمن في أنسٍ دائمٍ بربه ورضا داخلي لا تدركه الحواس، بل تعيشه الأرواح. وهي ثمرة الإيمان الصادق الذي يجمع بين المعرفة بالله، ومحبته، والخضوع لأمره.
أما من اقتصر على المظاهر دون الجوهر، فلن يجد في العبادة سوى التعب، لأن روحها في الإخلاص واليقين لا في الحركات والطقوس.
وهكذا، فإن النعيم الحقيقي هو نعيم القلوب قبل نعيم القصور، وجنة القرب من الله هي التي تسبق جنة الخلد في الآخرة؛ فمن ذاقها في الدنيا فقد عرف طريق السعادة الأبدية.
التربية الأخلاقية في الإسلام
تُعدّ التربية الأخلاقية من أهم ركائز الدين الإسلامي، إذ ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببناء شخصية الإنسان وضبط سلوكه وفق القيم والمبادئ التي دعا إليها القرآن الكريم والسنة النبوية. وتُعد الأخلاق في المنظور الإسلامي معيارًا لصدق الإيمان وصلاح الفرد والمجتمع، ولذلك اعتبر العلماء أن إصلاح الأخلاق من أعظم مقاصد الرسالة النبوية.
أهمية التربية الأخلاقية
يرى العلماء أن التربية الأخلاقية تمثل جوهر الدين، فهي الأساس الذي تُبنى عليه سائر العبادات والمعاملات. قال النبي محمد ﷺ:
«إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق» – رواه مالك في الموطأ
ويُعدّ الصدق في القول والعمل من أبرز الأخلاق التي أكد الإسلام على أهميتها، في حين حذّر من الكذب والخيانة وعدّهما من صفات المنافقين. جاء في الحديث الشريف:
«يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب» – رواه أحمد عن أبي أمامة الباهلي
خطورة الكذب في التربية
يُنظر إلى الكذب في التربية الإسلامية بوصفه من أخطر السلوكيات التي تُفسد بناء الشخصية وتضعف الثقة بين الأفراد. فالتربية الأخلاقية تبدأ من البيت، حيث يكتسب الأبناء القيم من خلال القدوة العملية أكثر من التوجيه اللفظي.
ويرى المربون المسلمون أن الممارسات التربوية المتناقضة – كأن يأمر الوالدان أبناءهم بالصدق بينما يكذبون أمامهم – تُفقد القيم الأخلاقية مصداقيتها. وقد ورد في الحديث الشريف:
«كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون» – رواه الترمذي عن أنس بن مالك
وبذلك يُعد الخطأ البشري أمرًا طبيعيًا، لكن الإصرار على الكذب يُعدّ انحرافًا أخلاقيًا ينافي صفات المؤمن. كما أشار بعض العلماء إلى أن الكذب في سلوك الأبناء مؤشر خطير يستدعي الملاحظة والمعالجة المبكرة.
الكذب والنفاق
يصف الحديث النبوي الكذب بأنه من علامات النفاق، إذ قال النبي ﷺ:
«أربع من كنّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» – رواه البخاري ومسلم
ويرى علماء الأخلاق أن تكرار الكذب يضعف الإيمان ويقود إلى فقدان الأمانة والصدق، وهما من القيم الأساسية في العلاقات الاجتماعية والأسرية. ويؤكد الفكر الإسلامي أن الأسرة هي البيئة الأولى لتنشئة الأبناء على الصدق والوفاء بالعهود، إذ تشكّل القاعدة الأخلاقية لسلوكهم في المجتمع.
التنوع في الطباع والأخلاق
تقرّ التربية الإسلامية بوجود اختلاف طبيعي في الطباع بين الناس؛ فالمؤمن قد يكون اجتماعيًا أو ميالًا للعزلة، متفائلًا أو متشائمًا، غنيًا أو فقيرًا، متعلمًا أو بسيط الثقافة، إلا أن القاسم المشترك بينهم هو الصدق والأمانة. وقد ورد في الحديث الشريف:
«يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب»
ويشير هذا إلى أن الإسلام لا يرفض الفروق الفردية في الشخصية، لكنه يضع حدودًا أخلاقية لا يجوز تجاوزها، وعلى رأسها الصدق في القول والأمانة في العمل.
الصدق في الحياة الزوجية
تناول الفقهاء مسألة الصدق والكذب بين الزوجين في ضوء الأحاديث النبوية، حيث ورد أن النبي ﷺ رخّص في الكذب اللفظي الذي يقصد به إصلاح العلاقة الزوجية، مثل التعبير المجازي عن الحب والمودة لدوام الألفة.
فقد فُهم من هذا الترخيص أنه يقتصر على الكلام الذي يرأب الصدع ويقوّي المودة، وليس على الكذب في الأمور المادية أو الواقعية التي قد تُفقد الثقة بين الزوجين. ويُروى أن النبي ﷺ عبّر عن حبه لعائشة رضي الله عنها بقوله: «كعقدة الحبل»، أي حب متين لا ينحلّ، وكان ذلك من باب الصدق في المشاعر لا المجاملة اللفظية.
أثر الصدق في بناء الشخصية
يرى علماء النفس والتربية أن الصدق قيمة مركزية في تكوين الشخصية المتوازنة. فالشخص الصادق يتمتع بالثقة بالنفس والاتزان الداخلي، بينما يؤدي الكذب إلى القلق والتناقض بين الظاهر والباطن.
كما تسهم القدوة الصالحة في غرس هذه القيمة، إذ يتعلم الأبناء من سلوك آبائهم أكثر مما يتعلمون من التعليم اللفظي. لذلك أكدت التربية الإسلامية أن الصدق أصل الأخلاق، وأن الكذب من أشدّ ما يفسد العلاقات الاجتماعية والتربوية.
خلاصة
تؤكد النصوص الشرعية والمصادر التربوية الإسلامية أن الأخلاق ليست مكمّلًا للدين، بل هي جوهره. وتُعد التربية الأخلاقية، وخاصة تربية الأبناء على الصدق والأمانة، من أعظم الواجبات التي تقع على عاتق الآباء والمربين. فصلاح الأخلاق هو الطريق إلى صلاح الفرد والمجتمع، والكذب والخيانة من أعظم ما يهدم هذا البناء.
أسباب هلاك الأمم في ضوء القرآن والسنة
يبيّن القرآن الكريم والسنة النبوية الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى هلاك الأمم، سواء بالدمار المباشر أو بالضعف والانحلال التدريجي، ويشير إلى أن هذه الأسباب تتعلق بالجانب الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي للأمة.
1. كثرة الفساد والخبث في الأرض
أول أسباب هلاك الأمم كما جاء في القرآن هو انتشار الفساد والخروج عن طاعة الله. قال تعالى:
﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ [الإسراء: 16].
يفسر العلماء ذلك بأن الأمم التي تكثر فيها الفساد والخبث، سواء عبر عصيان المترفين أو سكوت العامة عن الفساد، تصبح مستحقة للهلاك. وقد أشار الحديث الصحيح عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها إلى أن كثرة الفساد تؤدي إلى العقاب الإلهي حتى في وجود صالحين.
2. عدم شكر النعم
سبب آخر مذكور في القرآن هو كفر النعم، أي الإعراض عن شكر الله على ما أنعم به. قال تعالى:
﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ [النحل].
3. الغش والتطفيف في الميزان ونقض العهود
من أسباب الهلاك أيضًا التطفيف في الكيل والميزان، ومنع حقوق الناس، ونقض العهود والمواثيق. قال النبي ﷺ:
«يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ... وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ» [ابن ماجه].
هذا يشمل جميع صور الغش والخيانة الاقتصادية والاجتماعية.
4. التنافس على الدنيا
التنافس المادي والحرص على ملذات الدنيا دون اعتناء بالجانب الروحي يؤدي إلى هلاك الأمم. قال النبي ﷺ:
«فَوَ اللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخَشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا» [متفق عليه].
5. التعامل بالربا وانتشار الزنا
الأعمال المحرمة ماليًا وأخلاقيًا مثل الربا والزنا تؤدي إلى فساد المجتمع وعقاب الله، قال تعالى:
﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ ﴾ [البقرة: 275].
6. تقصير الدعاة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الأمة تهلك إذا تخلى الدعاة والقادة عن أداء واجبهم في النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. قال النبي ﷺ:
«مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَعَزُّ وَأَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ لَمْ يُغَيِّرُوهُ إِلَّا عَمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ» [أبو داود].
7. ترك الجهاد والإخلاد إلى الأرض
ترك الجهاد المشروع والبناء والتضحية من أجل الأمة يؤدي إلى الهوان والذل. قال النبي ﷺ:
«إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ... وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا» [أبو داود، أحمد].
8. مخالفة أمر النبي ﷺ والغلو في الدين
مخالفة أوامر النبي ﷺ أو الغلو في الدين يؤدي إلى هلاك الأمم، كما جاء في القرآن والسنة:
﴿ فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63]
وقال النبي ﷺ: «وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي» [أحمد].
طرق النجاة وبناء الأمة
يؤكد القرآن والسنة أن تجديد الإيمان والعمل الصالح، وتقوية الأخوة بين المسلمين، وتحويل العلم إلى فعل، والالتزام بالنهج الإسلامي في شؤون الحياة كافة، هي طرق النجاة من الهلاك.
تجديد الإيمان: النبي ﷺ قال: «إن الإيمان ليخلق ـ يضعف أو يهترئ ـ، فسلوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم» [الطبراني].
العلم مع العمل: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ» [متفق عليه].
الأخوة الصحيحة: «المؤمنون إخوة» [متفق عليه].
تحويل المعرفة إلى عمل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: 2-3].
الخلاصة
هلاك الأمم مرتبط دائمًا بانحرافها الأخلاقي والاجتماعي والروحي، وعوامل الهلاك الأساسية تشمل الفساد، كفر النعم، الغش، التنافس المادي، الربا والزنا، التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك الجهاد المشروع، مخالفة أوامر النبي ﷺ والغلو في الدين.
ومن جهة أخرى، النجاة والبناء يتطلب إصلاح الفرد والمجتمع عبر الإيمان والعمل، وتقوية الأخوة، والالتزام بالقيم الإسلامية.
الصدق في التربية الإسلامية
يُعدّ الصدق من القيم الأساسية في الإسلام، ومن أهم ما تُبنى عليه التربية الأخلاقية للأبناء. وقد أولى الإسلام هذه الفضيلة مكانةً عظيمة في العقيدة والسلوك، إذ جعلها أساسًا للبرّ، وسببًا للفلاح في الدنيا والآخرة. ويرى العلماء أن الصدق ليس مجرد صفةٍ خُلُقية، بل هو منهج حياة يشمل القول والعمل والنية.
أهمية الصدق في الأسرة
تُعتبر الأسرة البيئة الأولى لغرس القيم الأخلاقية، ويُعدّ الصدق من أبرز القيم التي يجب أن يرسخها الوالدان في نفوس الأبناء منذ الصغر. فالبيت الذي يقوم على الصدق هو بيت تسوده الطمأنينة والثقة المتبادلة، بينما يُعد الكذب مصدرًا رئيسيًا للنزاع وسوء الفهم داخل الأسرة.
يقول المربّون المسلمون إن أعظم ما يقدمه الأب لابنه هو أن يعلمه الصدق، لأن الصدق يولّد الشجاعة والثقة بالنفس، بينما يرسّخ الكذب الخوف والضعف الأخلاقي. وقد ورد في الحديث الشريف:
«عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار» – رواه البخاري ومسلم.
أثر القدوة في ترسيخ الصدق
تُشير التربية الإسلامية إلى أن القدوة العملية أقوى وسيلة لغرس القيم من التوجيه اللفظي. فالطفل يتعلم من سلوك والديه أكثر مما يتعلم من أقوالهم. فإذا طلب الوالد من ابنه الصدق ثم كذب أمامه، فإن تأثير الفعل السلبي يلغـي كل التوجيهات السابقة. لذلك قال العلماء إن “الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم”.
وتوصي التربية الإسلامية الوالدين بعدم معاقبة الطفل إذا قال الحقيقة، حتى لا يتعلم الكذب تجنبًا للعقاب، بل ينبغي تشجيعه على الاعتراف بالخطأ والصدق في القول.
أنواع الكذب وآثاره
يرى الفقهاء أن الكذب يتنوع في صوره وأسبابه، فقد يكون بالمبالغة أو بالتقليل أو بالإخفاء المتعمد للحقائق. وتُعدّ جميع هذه الأشكال مخالفةً للأمانة التي أمر بها الإسلام.
وقد ورد في الحديث الشريف:
«كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثًا هو لك مصدق وأنت له كاذب» – رواه الإمام أحمد عن نواس بن سمعان.
ويُعدّ الصدق أمانةً والكذب خيانةً، إذ يؤدي إلى فقدان الثقة وتفكك العلاقات الاجتماعية. ويرى علماء الأخلاق أن الكذب المتكرر يولّد النفاق، كما في الحديث النبوي:
«أربع من كنّ فيه كان منافقًا خالصًا: إذا اؤتمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» – رواه البخاري ومسلم.
الصدق في المواقف العملية
يُبرز الفكر التربوي الإسلامي نماذج عملية تبين أثر الصدق في السلوك الإنساني. فقد وردت قصص عن رجال التزموا الصدق رغم العواقب، منهم من تحمّل الخسارة المادية أو المسؤولية القانونية دون أن يخالف الحقيقة، فكان صدقهم سببًا في نجاتهم ورفعة مكانتهم.
ومن الأمثلة المشهورة قصة عبد القادر الجيلاني في صغره، حينما التزم الصدق في موقفٍ مع قطاع الطرق، فكان صدقه سببًا في توبتهم، مما يبرز أثر الصدق في تغيير النفوس.
الصدق والرقابة التربوية
تشير التربية الإسلامية إلى أن المتابعة والمساءلة جزء من التربية الصادقة. فالأب الذي يتحقق من أقوال أبنائه ويواجههم بالحقيقة يعلّمهم أن الكذب لا يمر دون تدقيق، مما يغرس فيهم الانضباط والصدق في المواقف اللاحقة.
بينما إهمال المتابعة يجعل الكذب سلوكًا مريحًا ومتكرّرًا. ولذلك يرى المربّون أن كثيرًا من أخطاء الأبناء ترجع إلى إهمال الآباء في المراقبة والمتابعة منذ الصغر.
الصدق في التربية الحديثة
تشير الدراسات التربوية والنفسية الحديثة إلى أن الصدق في الأسرة يعزز الثقة والأمان العاطفي بين الآباء والأبناء، ويحد من القلق الاجتماعي وسلوكيات الخداع. كما أن الأطفال الذين ينشؤون في بيئة صادقة أكثر قدرة على تحمل المسؤولية والاعتراف بالأخطاء دون خوف.
من جهة أخرى، يؤكد علم النفس التربوي أن المكافأة على الصدق – وليس مجرد العقاب على الكذب – تساعد في بناء الضمير الأخلاقي لدى الطفل. وهذا يتوافق مع التوجيه الإسلامي القائل إن «الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة».
شمولية الصدق
يؤكد الإسلام على شمولية الصدق في جميع نواحي الحياة، داخل الأسرة وخارجها، في القول والعمل والمعاملة. فلا يجوز الكذب حتى في الأمور البسيطة أو المزاح، إذ ورد أن النبي ﷺ قال لامرأة واعدة ابنها بتمرة:
«أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة» – رواه أبو داود..
ويرى علماء السلوك أن الالتزام بالصدق في المواقف الصغيرة يبني شخصية متماسكة، لأن الكذب في الأمور التافهة يفتح الباب للكذب في القضايا الكبرى.
خلاصة
تؤكد التربية الإسلامية أن الصدق قيمة شاملة تُعبّر عن صفاء القلب واستقامة السلوك، وأنه أصل كل فضيلة. وأعظم ما يقدمه الأب لابنه هو أن يكون قدوةً في الصدق قولًا وفعلاً، لأن القيم تُكتسب بالمشاهدة أكثر من التعليم.
فإذا تربّى الأبناء في بيئة صادقة، نشأوا على الأمانة والعدل والإخلاص، وإذا انتشر الصدق في المجتمع، ساد فيه الأمن والثقة، وانخفضت مظاهر الخداع والنفاق.
ولهذا يُعد الصدق في التربية الإسلامية مفتاح البرّ والهداية، وأساس بناء الإنسان الصالح والأسرة المستقرة والمجتمع المتماسك.
